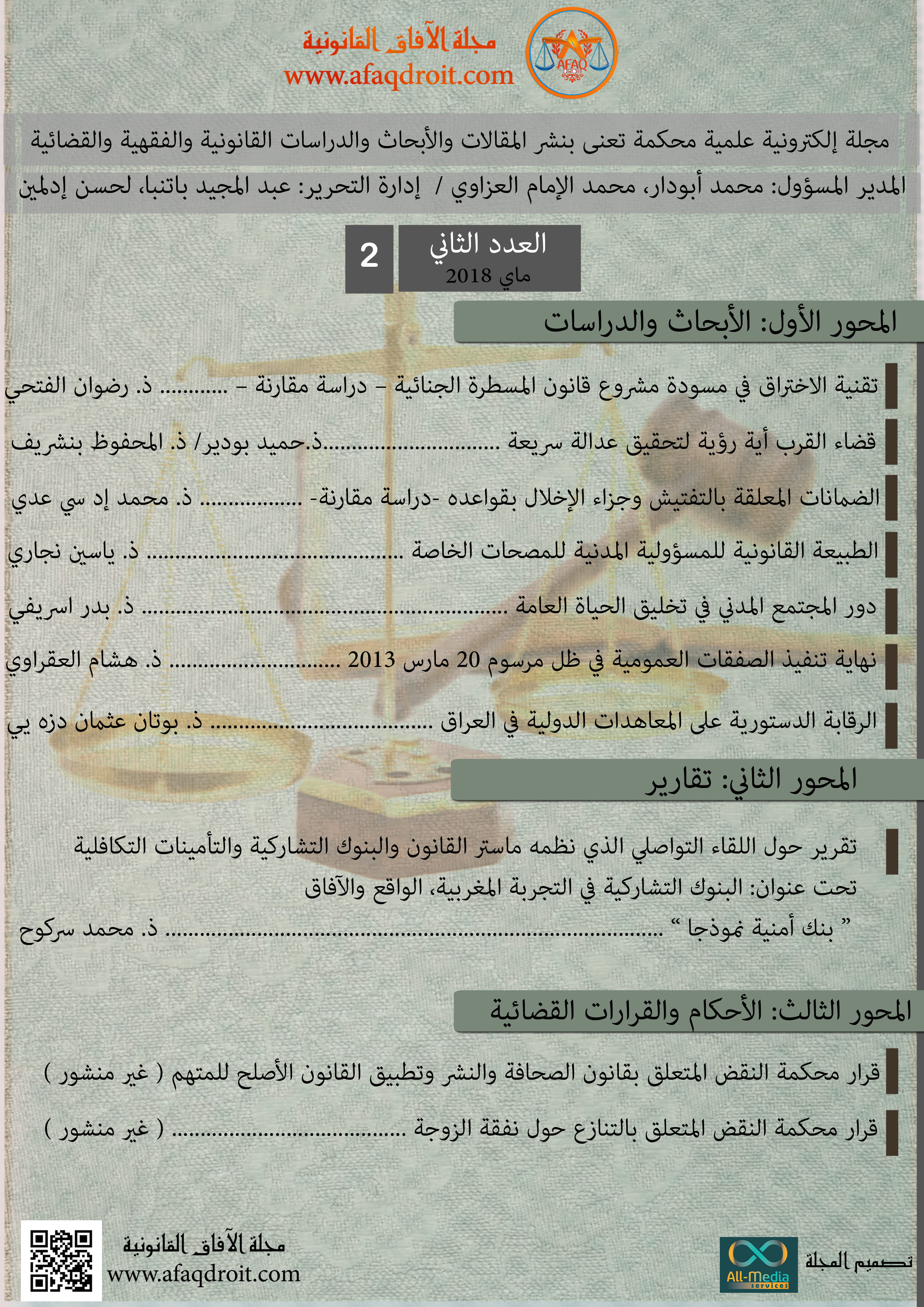أمسى النظام القانوني لازمة من لوازم الدولة الحديثة، يبسط قواعد السلوك، ويؤطر حدود التعامل، ويحفظ موازين السلم الاجتماعي، ومهما قيل عن هيمنة القانون على مفاصل النشاط الانساني، وتدخله في تكوين الهياكل الرسمية في الدولة العصرية، فإن القانون في نهاية المطاف هو العلامة الفارقة في شرعية النظم الاجتماعية على تفاوت مراتبها.
صحيح أن بعض الشعوب قديمة الصلة بالقانون، ولكن ذلك لا ينفي إمكانية الوصول إلى ما يشارف درجتها في الجانب التشريعي من الحضارة الإنسانية. وسبيل ذلك هو إشاعة ثقافة القانون بين الأفراد، وتنمية الشعور بأهمية المبادئ والمثل القانونية الكفيلة بترسيخ معاني العدالة في السلوك العام. وليس ذلك بالامر اليسير، فالنداءات المتكررة في صورة شعارات إعلامية، لا تغني في هذا المجال شيئاً، وإن أدت إلى استيعاب الذاكرة الجماعية بعض مفردات القانون، فما قيمة معرفة النص ما دام العارف به بعيداً عن الانفعال بمعناه.
إن التثقيف العام بمبادئ القانون، وهو أمر آخر خلاف التعليم المتخصص، من أوجب الأهداف الاجتماعية التي تسعى إليها الدول المعاصرة. فالثقافة القانونية عند المواطن تشرب نفسه باحترام حقوق الإنسان، ومثل هذا الاحترام رادع له عن الاعتداء على حقوق الآخرين، وزاجر له عن تجاوز حدود حقه الشخصي، إنها ثقافة تصون حقوق المستخدم والأجير، وحقوق الطفل والمرأة، ثقافة تدعو إلى احترام العهود والعقود والمواثيق، وتعود صاحبها على الاحتكام لقواعد الاختصاص في تعامله مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، مما يسهل عليها تنفيذ آليات عملها، مثلما يفرض عليها رقابة شعبية في تقويم أداءاتها مع الأفراد. وفي الجملة فإن الثقافة القانونية تساعد الشخص على مزيد خمن التعقل للأمور، وعلى تجنب الخطأ، وصيانة الحقوق، ومعرفة مواطن المسؤولية وأشكال الجزاء.
ليس صعباً أن يميز المرء ما بين طبائع المثقف قانونياً، وطبائع المتجرد من ذلك التثقيف. فالشخصية الانسانية تتأثر تلقائياً بما تكتسبه من قيم ومبادئ علمية، ويظهر ذلك التأثر في جانب التهذيب الخلقي للإنسان، وهذه وإن لم تكن قاعدة عامة، لما شذ عنها من صور الانحراف في سلوك طائفة من المثقفين فإن مرد ذلك إلى وعي النفس بقيمة المبادئ التي تتلقاها، وحرصها على الارتقاء في سلم الكمالات الإنسانية، فتسهم تلك الثقافة في الحد من تهورها، والتحكم في أهوائها.
لقد درج علماء القانون على التفريق ما بين القاعدة الخلقية والقاعدة القانونية، واصفين الأولى بأنها التي تهدف لكمال الإنسان وتهذيبه والسمو به إلى مراتب المثل العليا، والثانية بأنها قاعدة سلوكية ملزمة، تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، إلا أنهم قرروا أيضاً اشتراك النوعين من القواعد في المقاصد العامة التي تتجلى في خير المجتمع وأمنه ورقيه. ومن مظاهر الاشتراك أن قواعد الأخلاق تدين هي وقواعد التجريم سواء بسواء السلوك المؤثم في القانون العقابي، كما تشترك قواعد الأخلاق مع قواعد المعاملات في ترسيخ مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات، وإقامة التوازن العادل بين الالتزامات، ومن أجل ذلك نادى كثير من المتشرعين بضرورة استناد القانون إلى قواعد الأخلاق، ونبهوا إلى أن الأخلاق مصدر رئيسي من مصادر تكوين القاعدة القانونية، فالعدل باعتباره غاية القانون، وثيق الصلة بالاعتبارات الأخلاقية لا يكاد ينفك عنها إلا في الضرورات القصوى ولاعتبارات اجتماعية، مثلما رأينا في تشريع قاعدة انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط وما يتخلف عنه من التزام طبيعي، وسن التشريعات الاستثنائية في مجالات الايجار والعمل ونزع الملكية.
إن الفضيلة الأخلاقية ليست موجهة للمشرع فحسب، ولكنها أيضاً موجهة للقاضي في الفهم الصحيح للنصوص التشريعية، والفهم سابق على التطبيق، وموجهة له أيضاً عند خلو التشريع من نص يحكم النازلة المعروضة عليه، وقد ورد في القانون أنه “إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة”. وهل قواعد العدالة إلا جماع الفضائل الأخلاقية يتعقلها القاضي بإرادة واعية، وبصيرة مدركة، يعمل معها قواعد السبر والتقسيم، والتمحيص والترجيح، وإن من لطائف التقنين المدني السويسري أنه عالج هذه المسألة في الفقرة الثانية من المادة الأولى بقوله: “عند عدم وجود نص في القانون، يحكم القاضي بالقانون الذي كان يسنه لو كان هو مشرعاً ويتبع التقاليد المعمول بها”، وهكذا أنزل القاضي في هذه الجزئية منزلة المشرع بأن يطبق ما كان ليصنعه هو من قواعد لو عهد إليه بأمر التشريع.
ولا يقال هنا إن هذه المسألة بعيدة عن التطبيق، لأن المشرع المدني القطري عهد إلى القاضي بهذه الوظيفة في عدد من المواد من خلال الإحالة إلى قواعد العدالة، كالمادة 79 فقرة ثانية التي تقول “وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة”.
وكالمادة 80/ 2، والمادة 106، والمادة 172 إلى غير ذلك من مواد القانون، غير أن الكبرى منها في منح التفويض هي المادة 918 التي تتكلم عن الالتصاق بالمنقول، حيث حذف واضع المشروع عبارة الأصل المقتبس منه، وهي: الاسترشاد بقواعد العدالة، وهو نهج غير سديد، لأنه ترك المحكمة دون ارشاد إلى مصدر من مصادر القاعدة القانونية.
لا بد إذن من بث مفاهيم الأنظمة القانونية النافذة، وترسيخ مبادئها في وجدان المجتمع، لتحقيق الغايات النبيلة المقصودة من تشريعات الدولة، ولا ريب أن هذه الرسالة ذات جانب علمي يلقي بظلاله على أهل الاختصاص، للتفاعل مع قضايا ومسائل القانون بحثاً وتأصيلاً، ومحاورة ونشراً، نظراً لحاجة المكتبة القطرية إلى دراسات جادة في جميع فروع القانون، أملاً في مستقبل زاهر يتبوأ فيه التشريع القطري مكان الريادة، ويأخذ موضعه بين التشريعات التي يحتذى على مثالها.
بقلم : د. محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي
أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة قطر